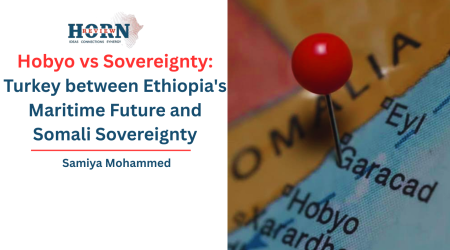7
Oct
إريتريا المُفككة: حجة تراجع إثيوبيا
وصف اعتراف إثيوبيا بانفصال إريتريا عام ١٩٩٣ بأنه بادرة مصالحة تاريخية، إذ أشار إلى أن العقود من الحرب الأهلية قد وصلت إلى نقطة تحول وأن عهداً جديداً من التعاون قد ينبثق بين الحكومة القادمة بقيادة جبهة تحرير شعب تغراي (TPLF) في أديس أبابا، وجبهة تحرير شعب إريتريا (EPLF) حليفتها الحربية ضد نظام الديرغ. في ذلك الوقت، كان الاعتراف مُلائماً سياسياً لكل من قيادتي جبهة تحرير شعب تيغراي وجبهة تحرير شعب إريتريا، إلا أنه كان محل نزاع أخلاقي واستياء واسع النطاق من الإثيوبيين في الداخل والخارج. خاضت إريتريا حرباً طويلة ودموية تحت شعار “تقرير المصير”، وإثيوبيا، المُنهكة من صراع طويل، مدت يد الشرعية من دولة إلى أخرى – ما يصفه القانون الدولي غالباً بـ “إذن الدولة الأم”. ومع ذلك، فقد مُنح هذا الاعتراف أو موافقة الدولة ذات السيادة من قِبَل حكومة انتقالية دون تفويض شرعي للقيام بذلك، ودون الضمانات اللازمة للإجراءات الحكومية الإثيوبية. لم يُعرض ملس زيناوي وزملاؤه في الحكومة التي تقودها جبهة تحرير شعب تيغراي المسألة على البرلمان للتصديق عليها، ولم يسعوا إلى تأكيد الإرادة السياسية للشعب الإثيوبي من خلال أي عملية شرعية.
تجاهل هذا التنازل الأحادي الجانب التحذيرات الصريحة من الشركاء الأمريكيين والغربيين الآخرين، الذين نصحوا إثيوبيا بتأجيل الاعتراف حتى يتم ترسيم الحدود بوضوح. وقد أدى هذا الفشل في معالجة المسائل الإقليمية العالقة إلى زرع بذور الصراع، الذي بلغ ذروته في الحرب الإثيوبية الإريترية بين عامي 1998 و2000 – وهو تذكير مدمر بأن الاعتراف السابق لأوانه، الذي مُنح دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو استشراف استراتيجي، يحمل عواقب وخيمة على سيادة إثيوبيا وأمنها.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن شرعية دولة إريتريا في السياسة الدولية كانت راسخة بقوة في الإرادة السياسية لجبهة تحرير شعب تيغراي التي أدت إلى موافقة إثيوبيا على منح إريتريا صفة الدولة. كان هذا الاعتراف بمثابة الإشارة الأساسية التي مكّنت الدول الأخرى والهيئات الدولية والإقليمية من معاملة إريتريا كدولة ذات سيادة. لولا هذه الموافقة، لكانت إريتريا على الأرجح قد واجهت نفس مصير كيانات مثل استقلال أرض الصومال القصير عام ١٩٦٠، ومحاولة كاتالونيا للانفصال عام ٢٠١٧، أو إعلان بيافرا عام ١٩٦٧ وغيرها من الحالات التي قوبل فيها الاعتراف دون موافقة الدولة الأم بمقاومة شديدة أو أنها باءت بالفشل سريعاً.
وتُعدّ قضية بيافرا ذات دلالة خاصة، فَرَغْمَ أن حفنة من الدول قدّمت اعترافها، إلا أن غياب موافقة نيجيريا جعل هذا الاعتراف هشاً وغير مستدام، وأُعيد استيعاب بيافرا في النهاية. تُؤكد هذه السوابق حقيقةً أوسع نطاقاً: نادراً ما يدوم الاعتراف دون موافقة الدولة الأم، بينما معه، حتى المطالبات المتنازع عليها يمكن أن تكتسب زخماً. وقد اشترطت الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي صراحةً قبول الدول المذكورة أعلاه باعتراف سيادتها، بما في ذلك اعتراف إريتريا. ومن ثم، يشير هذا النمط الأوسع من الممارسات الدولية إلى أن منح إثيوبيا للشرعية كان لا غنى عنه – ليس مجرد إجراء شكلي، بل كان العامل الحاسم الذي حوّل إريتريا من حركة تمرد إلى دولة معترف بها.
ومع ذلك، وبعد ثلاثة عقود، ثبت أن التفاؤل الذي عزز هذا الاعتراف في البداية كان في غير محله. فقد فشلت إريتريا في أن تصبح جارة مسؤولة أو دولة قابلة للحياة بأي معنى حقيقي. بل رسخت نفسها كقوة مزعزعة للاستقرار، تقوض أمن إثيوبيا باستمرار، وتعيق طموحاتها التنموية، وتتحالف مع قوى معادية مثل مصر لاحتواء نفوذ إثيوبيا وعرقلة طموحاتها البحرية.
في ضوء هذا المسار، يبرز سؤال صعب ولكنه لا مفر منه: هل يُتوقع من إثيوبيا أن تتمسك بالاعتراف إلى أجل غير مسمى في حين أن الدولة التي شرّعتها قد تحولت إلى كيان مختل، ومصدر لعدم الاستقرار والعداء المتواصل؟ إن الأسباب القانونية والاستراتيجية لطرح مثل هذا السؤال ليست بلا أساس. فالاعتراف بالدولة، في جوهره، عمل سيادي وتقديري؛ وهو ليس دائمًا ولا نهائيًا. ولا يُلزم القانون الدولي الدولة بتأبيد الاعتراف إذا تآكلت الشروط التي بررته في المقام الأول.
يُقدم التاريخ سوابق عديدة: التحول الدبلوماسي من تايوان إلى جمهورية الصين الشعبية، وإلغاء الاعتراف بألمانيا الشرقية عند إعادة توحيدها، أو سحب الاعتراف من كيانات انهارت، أو توقفت عن العمل بفعالية كدول، أو تصرفت بخبث. يمكن إيجاد سابقة أفريقية بارزة في حالة أرض الصومال. فعند إعلان استقلالها عن بريطانيا في يونيو/حزيران 1960، اعترفت بها عدة دول لفترة وجيزة، بل وتبادلت معها العلاقات الدبلوماسية. ومع ذلك، في غضون أيام، سُحب هذا الاعتراف فعلياً عندما اختارت أرض الصومال الاتحاد مع الصومال المستقلة حديثاً. توضح هذه الحادثة أن الاعتراف ليس ثابتاً: يمكن تمديده، أو حجبه، أو حتى إلغاؤه تبعاً لتغير الظروف السياسية والاستراتيجية. هذا المثال ذو أهمية خاصة لإثيوبيا، إذ يُبرز أن ممارسات الدول الأفريقية نفسها تُقرّ بسيولة الاعتراف، مما يُقوّض الافتراض القائل بأنه بمجرد تمديده، يجب أن يستمر الاعتراف بغض النظر عن التطورات اللاحقة.
تحتفظ إثيوبيا، بصفتها “الدولة الأم”، بمكانة قانونية واستراتيجيّة أكثر استثنائية في هذا السياق. فقد أُضفيَت الشرعية على الأراضي الإريترية المنفصلة بموافقتها، وعندما تُنتهك الافتراضات التي تقوم عليها هذه الموافقة، يُمكن للدولة الأم إعادة النظر في قرارها بشكل مشروع. هذا ليس مجرد قلق نظري، بل يكتسب أهمية بالغة عند قياسه بالوضع الفعلي لإريتريا، لأن الدولة، بكل المعايير تقريباً، لم تعد تعمل بطريقة تتسق مع التوقعات الدولية للسيادة.
تُحدد اتفاقية مونتيفيديو أربعة معايير أساسية للدولة: سكان دائمون، إقليم مُحدّد، حكومة فعّالة، والقدرة على الانخراط في علاقات خارجية. إريتريا اليوم مُتعثرة في جميع هذه المعايير تقريباً. يتراجع عدد سكانها بشكل حاد، إذ تدفع الخدمة الوطنية غير المحدودة الأجل، والتجنيد الإجباري، والهجرة الجماعية الملايين إلى الفرار – لا سيما إلى إثيوبيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأوغندا ورواندا وكينيا وجنوب إفريقيا – مما يستنزف شباب البلاد وحيويتها. يحكم البلاد نظام مركزي صارم في ظل نظام الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، الذي تحول الآن إلى نظام الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، والذي يتمسك بالسلطة من خلال الإكراه العسكري بدلاً من المؤسسات الخاضعة للمساءلة؛ تفتقر إريتريا إلى دستور ومؤسسات فاعلة. لم تُجرِ انتخابات منذ انفصالها عام ١٩٩٣، وتفتقر إلى أي آليات موثوقة لإنفاذ القانون أو تقديم الخدمات العامة المشروعة.
اقتصادياً، لا يزال اقتصادها راكداً، معتمداً على التحويلات المالية القسرية من مواطنيه في المنفى، ومشاريع التعدين الاستخراجية، والعمل القسري، في حين أن العقوبات والعزلة لم تؤدي إلا إلى تعميق هشاشتها. حتى في العلاقات الخارجية، تتصرف إريتريا كمفسد انتهازي أكثر منها كدولة ذات سيادة – متحالفة مع جهات فاعلة معادية كمصر، ليس لتعزيز الاستقرار أو التعاون، بل لتقييد طموحات إثيوبيا التنموية وخياراتها الإقليمية.
إذا بقيت تساؤلات حول ما إذا كانت إريتريا قد انهارت كدولة فاعلة، فإن سجلها في مجال حقوق الإنسان يقدم إجابة حاسمة. تُفصّل تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية واقعاً قاتماً: خدمة وطنية غير محددة المدة، وعمل قسري يوقع حتى القُصّر في الفخ، واعتقالات تعسفية، وقمع ممنهج لحرية التعبير، ومناخ خوف متفشٍّ لا يترك مجالاً للمجتمع المدني. في عام ٢٠٢٤، صنّف مؤشر الدول الهشة إريتريا من بين أكثر الدول هشاشةً وخطورةً على مستوى العالم، وهو انعكاسٌ للثقل المشترك للقمع السياسي والركود الاقتصادي والانهيار المجتمعي.
عسكرياً، سخّر النظام موارده لإدامة بقائه بدلاً من رفاهية شعبه، مُعزّزاً سلطته من خلال ثقافة الإكراه بدلاً من المؤسسات الخاضعة للمساءلة. هذه ليست إخفاقات عرضية، بل هي إخفاقات هيكلية: فهي تكشف عن دولةٍ أُفرغت هياكلها الداخلية من محتواها، ولا تستمد شرعيتها من الموافقة بل من الإكراه، وتغيب قدرتها الأساسية على الحكم فعلياً.
ومما يثير القلق أيضاً سلوك إريتريا خارج حدودها. فبدلاً من أن تكون جارةً مستقرة، برزت كعامل زعزعة استقرار دائم في منطقة القرن الأفريقي. فعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، أفادت التقارير أن إريتريا قدّمت التدريب والموارد والدعم اللوجستي للجماعات المتمردة داخل إثيوبيا – وآخرها لميليشيا أمهرة فانو، وجيش تحرير أورومو، وفصيل جبهة تحرير شعب تيغراي الذي انقسم إلى قسمين بعد اتفاق بريتوريا للسلام – مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الإقليمي وإطالة أمد الأعمال العدائية. لا يمكن اعتبار انحيازها الطويل الأمد إلى مصر – وهي جهة فاعلة ساهمت تاريخياً في صعود الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وتعزيز قدراتها العملياتية خلال ستينيات القرن الماضي – مجرد تعاون إقليمي. بل إنه يُشكل حساباً استراتيجياً مدروساً يهدف إلى تضييق نفوذ إثيوبيا وترسيخ سياسة الاحتواء الهيكلي المتأصلة في انفصال إريتريا المُدبّر بعناية، مما يضمن بقاء إثيوبيا مقيدة إقليمياً وجيوسياسياً.
إضافةً إلى ذلك، أبدت إريتريا استعدادها لنشر قوات قرب الحدود المتنازع عليها، مما أدى إلى تصعيد التوترات وإجبار إثيوبيا على الحفاظ على موقف دفاعي. وبعيداً عن إثيوبيا، عملت إريتريا مراراً وتكراراً ضد المؤسسات السياسية المستقرة في السودان وجيبوتي والصومال وجنوب السودان، مما قوّض جهود السلام والاستقرار والحوكمة. في الواقع، رسّخت إريتريا نفسها كقوة معادية للدولة بحكم الأمر الواقع – وبالأخص لإثيوبيا – تعمل كجهة فاعلة إقليمية معادية لجيرانها، وتُعيق باستمرار أمن إثيوبيا وتنميتها وطموحاتها الاستراتيجية الأوسع.
من الناحية القانونية، تُوفر هذه الحقائق أسباباً مُقنعة لإثيوبيا لإعادة النظر في اعترافها بإريتريا. لم تعد شروط الدولة والافتراضات التي مُنح على أساسها الاعتراف مُرضية. لقد انتهكت إريتريا التوقعات الوظيفية والمعيارية التي رافقت اعترافها، وانخرطت في سلوك يُقوّض ليس فقط مصالح إثيوبيا، بل أيضاً الاستقرار الإقليمي الأوسع. حتى لو استمرت في الوجود كدولة اسمية، فإن إثيوبيا تحتفظ بالسلطة السيادية لإلغاء الاعتراف، مُسترشدةً بالمبدأ القانوني والضرورة الاستراتيجية.
من الناحية الاستراتيجية، من شأن إلغاء الاعتراف أن يُنزع الشرعية عن دولة تعمل كخصم بالوكالة، ويُشير إلى أن السيادة تستلزم المساءلة. كما أنه سيُمكّن إثيوبيا من إعادة تأكيد مطالبها على سكان مهمّشين ذوي مصالح وحدوية تحتل أراضٍ حيوية. وعلى نطاق أوسع، سيُعيد تأكيد معايير الدولة ويُعزز مبدأ أن مجرد الوجود لا يُضفي الشرعية، لا سيما عندما تُصبح الدولة أداةً للقمع وعدم الاستقرار والتدخل المُستمر في شؤون جيرانها.
كما أن إلغاء الاعتراف لن يكون رمزياً فحسب؛ مع أن سحب الاعتراف لن يُلغي فوراً صفة الدولة الرسمية لإريتريا، إلا أنه سيُغيّر موقعها في منطقة القرن الأفريقي جذرياً، ويُعيد ترتيب حساباتها الإقليمية. تاريخياً، كان سحب الاعتراف بمثابة رافعة دبلوماسية لإجبارها على إعادة التفاوض على الحدود أو النفوذ أو الحوكمة، كما حدث في حالات مثل ألمانيا الشرقية قبل إعادة التوحيد، أو انخراط باكستان المشروط مع بنغلاديش في أوائل سبعينيات القرن الماضي. بالنسبة لإريتريا، من شأن هذه الخطوة أن تُنزع الشرعية عن المطالبات الأحادية الجانب بالأراضي والسيادة، لا سيما في المفاوضات المتعلقة بسعي إثيوبيا للوصول إلى البحر، وأن تُقيّد قدرتها على تأمين الدعم الدولي.
لطالما استُخدم الاعتراف بمرونة كأداة للتأثير على وضع المناطق المنفصلة والتفاوض بشأن النزاعات الحدودية أو الحوكمة، لا سيما عندما يفشل كيان انفصالي في استيفاء المعايير الوظيفية والمعيارية المتوقعة من دولة ذات سيادة. من الناحية الاستراتيجية، سيُحوّل سحب إثيوبيا للاعتراف اعترافاً دبلوماسياً جامداً إلى أداة فعّالة للسياسة الواقعية الإقليمية، تُعيد تشكيل ميزان القوى وتُعيد ضبط الحوافز في جميع أنحاء القرن الأفريقي.
لا شك أن النقاد سيُثيرون اعتراضات. قد يُستشهد بمبدأ “الحيازة الجارية”، الذي يُحافظ على حدود الحقبة الاستعمارية، للطعن في إلغاء الاعتراف. ويمكن الاستشهاد باستمرار عضوية إريتريا في الأمم المتحدة كدليل على شرعيتها. قد تُثار تحذيرات من أن إلغاء الاعتراف سيزعزع استقرار القرن الأفريقي. ومع ذلك، لا يصمد أيٌّ من هذه الاعتراضات أمام التدقيق الكامل. يفترض مبدأ “الحيازة الجارية” وجود دول فاعلة ومسؤولة؛ بينما يُخرج انهيار إريتريا ونشاطها الخبيث هذا المبدأ من نطاق القضايا العادية. إن عضوية الأمم المتحدة تعني اعترافاً من النظراء، لا قدرةً داخليةً أو حوكمةً أو شرعيةً. ويجب موازنة القلق بشأن عدم الاستقرار مع حقيقة أن إريتريا نفسها مصدرٌ لعدم استقرارٍ مستمر، تُصدّر الصراع، وتدعم التمردات، وتُعيق تنمية إثيوبيا.
في نهاية المطاف، اتُّخذ قرار إثيوبيا عام ١٩٩٣ بأمل إحلال السلام والتعاون البنّاء؛ إلا أن سلوك إريتريا على مدى العقود الثلاثة الماضية حوّل هذا التوقع إلى مسؤولية. من الناحية القانونية، تحتفظ إثيوبيا بحق سحب الاعتراف. ومن الناحية الاستراتيجية، لديها كل الأسباب للقيام بذلك. لقد انهارت إريتريا كدولةٍ من حيث الجوهر، وهي تُزعزع استقرار المنطقة بنشاط، وتُعيق طموحات إثيوبيا الأمنية والتنموية المشروعة. يُعدّ الاعتراف تنازلاً سيادياً قابلاً للإلغاء؛ وهذه السيادة تعني القدرة على إعادة التقييم والاستجابة عندما تتغير الظروف جذرياً. إن السماح باستمرار مسار إريتريا الحالي دون رادع يعني التسليم بأن جيباً معطلاً، معادياً، وقمعياً قد يُقيّد إلى أجل غير مسمى إحدى أكبر دول أفريقيا وأكثرها ديناميكية. وبالتالي، فإن إلغاء الاعتراف سيُشكّل تأكيداً قاطعاً على القانون والاستراتيجية والمبادئ – استعادةً للسيادة ومستقبل الأمة.